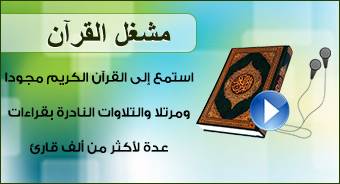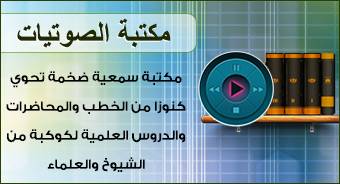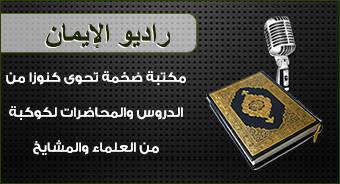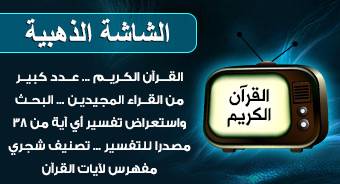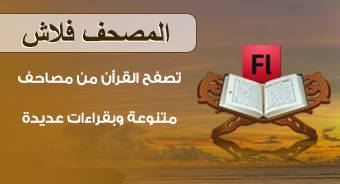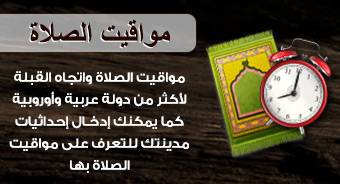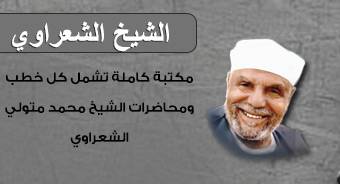|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (نسخة منقحة)
وهذا كثير، وباقي الآية بين، وقوله تعالى {وأحيط بثمره} الآية، هذا خبر من الله عن إحاطة العذاب بحال هذا المثل به، وقد تقدم القول في الثمر، غير أن الإحاطة كناية عن عموم العذاب والفساد، و{يقلب كفيه} يريد يضع بطن إحداهما على ظهر الأخرى، وذلك فعل المتلهف المتأسف على فائت وخسارة ونحوها، ومن عبر بيصفق فلم يتقن، وقوله: {خاوية على عروشها} يريد أن السقوف وقعت، وهي العروش، ثم تهدمت الحيطان عليها، فهي خاوية، والحيطان على العروش {ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً} قال بعض المفسرين: هي حكاية عن قول الكافر هذه المقالة في الآخرة، ويحتمل أن يريد أنه قالها في الدنيا على جهة التوبة بعد حلول المصيبة ويكون فيها زجر للكفرة من قريش أو غيرهم، لئلا تجيء لهم حال يؤمنون فيها بعد نقم تحل بهم، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وأبو عمرو والحسن وأبو جعفر وشيبة: {ولم تكن} بالتاء على لفظة الفئة، وقرأ حمزة والكسائي ومجاهد وابن وثاب {ولم يكن} بالياء على المعنى، الفئة الجماعة التي يلجأ إلى نصرها، قال مجاهد هي العشيرة.قال القاضي أبو محمد: وهي عندي من فاء يفيء وزنها فئة، حذفت العين تخفيفاً، وقد قال أبو علي وغيره: هي من فاوت وليست من فاء، وهذا الذي قالوه أدخل في التصريف، والأول أحكم في المعنى، وقرأ ابن أبي عبلة: {فئة تنصره}، وقوله: {هنالك} يحتمل أن يكون ظرفاً لقوله: {منتصراً} ويحتمل أن تكون {الولاية} مبتدأ، و{هنالك} خبره، وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب {الوِلاية} بكسر الواو، وهي بمعنى الرياسة والزعامة ونحوه، وقرأ الباقون {الوَلاية} بفتح الواو وهي بمعنى الموالاة والصلة ونحوه، ويحكى عن أبي عمرو والأصمعي أن كسر الواو هنا لحن، لأن فعالة، إنما تجيء فيما كان صنعة أو معنى متقلداً، وليس هنا تولي أمر الموالاة، وقرأ أبو عمرو والكسائي {الحق} بالرفع على جهة النعت ل {الولاية}، وقرأ الباقون {الحقِّ} بالخفض على النعت {لله} عز وجل، وقرأ أبو حيوة {لله الحقَّ} بالنصب وقرأ الجمهور {عُقُباً} بضم العين والقاف وقرأ عاصم وحمزة والحسن {عُقْباً} بضم العين وسكون القاف وتنوين الباء، وقرأ عاصم أيضاً {عقبى} بياء التأنيث، والعُقُب والعُقْب بمعنى العاقبة.
والهشيم المتفتت من يابس العشب، ومنه قوله تعالى {كهشيم المحتظر} [القمر: 31] ومنه هشم الثريد، و{تذروه}، بمعنى تفرقه، وقرأ ابن عباس: {تذريه}، والمعنى: تقلعه وترمي به، وقرأ الحسن {تذروه الريح} بالإفراد، وهي قراءة طلحة والنخعي والأعمش وقوله: {وكان الله} عبارة للإنسان عن أن الأمر قبل وجود الإنسان هكذا كان، إذ نفسه حاكمة بذلك في حال عقله، هذا قول سيبويه، وهو معنى صحيح وقال الحسن {كان}: إخبار عن الحال قبل إيجاد الموجودات، أي إن القدرة كانت، وهذا أيضاً حسن، فمعنى هذا التأويل تشبيه حال المرء في حياته وماله وعزته وزهوه وبطره بالنبات الذي خضرة ونضرة عن المطر النازل، ثم يعود بعد ذلك {هشيماً} ويصير إلى عدم، فمن كان له عمل صالح، يبقى في الآخرة فهو الفائز، فكأن الحياة بمثابة الماء والخضرة، والنضارة بمنزلة النعيم والعزة، ونحوه. وقوله: {المال والبنون زينة الحياة الدنيا} لفظ الخبر، لكن معه قرينة الضعة للمال والبنين لأنه في المثل، قبل حقر أمر الدنيا وبنيه، فكأنه يقول في هذه: إنما المال والبنون زينة هذه الحياة المحقرة، فلا تتبعوها نفوسكم، وقوله: {زينة} مصدر، وقد أخبر به عن أشخاص فإما أن يكون على تقدير محذوف، وتقديره مقر زينة الحياة الدنيا، وما أن نضع المال والبنين بمنزلة الغنى والكثرة، واختلف الناس في {الباقيات الصالحات} فقال ابن عباس وابن جبير وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل: هي الصلوات الخمس وقال الجمهور هي الكلمات المأثور فضلها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، روي في هذا حديث: {أكثروا من الباقيات الصالحات}، وقاله أيضاً ابن عباس، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة وغيره أن هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات، وقال ابن عباس أيضاً {الباقيات الصالحات}: كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة ورجحه الطبري، وقال ابن عباس بكل الأقوال دليل على قوله بالعموم، وقوله: {خير ثواباً وخير أملاً} صاحبها ينتظر الثواب وينبسط على خير من حال ذي المال والبنين دون عمل صالح، وقوله تعالى: {ويوم نسير الجبال} الآية التقدير: واذكر يوم، وهذا أفصح ما يتأول في هذا هنا، وقرأ نافع والأعرج وشيبة وعاصم وابن مصرف وأبو عبد الرحمن نسير بنون العظمة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والحسن وشبل وقتادة وعيسى: {تسيَّر} بالتاء، وفتح الياء المشددة {الجبالُ} رفع، وقرأ الحسن: {يُسيَّر} بياء مضمونة، والثانية مفتوحة مشددة، {الجبال} رفعاً، وقرأ ابن محيصن {تَسِير}: بتاء مفتوحة وسين مكسورة، أسند الفعل إلى {الجبال}، وقرأ أبي بن كعب {ويوم سيرت الجبال}.وقوله: {بارزة} إما أن يريد أن الأرض، لذهاب الجبال والظراب والشجر، برزت وانكشفت، وإما أن يريد: بروز أهلها، والمحشورين من سكان بطنها {وحشرناهم} أي أقمناهم من قبورهم، وجعلناهم لعرضة القيامة، وقرأ الجمهور {نغادر} بنون العظمة، وقرأ قتادة: {تغادر} على الإسناد إلى القدرة أو إلى الأرض، وروى أبان بن يزيد عن عاصم: {يغادَر} بياء وفتح الدال {أحدُ} بالرفع، وقرأ الضحاك {فلم نُغْدِر} بنون مضمومة وكسر الدال وسكون الغين، والمغادرة: الترك، ومنه غدير الماء، وهو ما تركه السيل، وقوله: {صفاً} إفراد نزل منزلة الجمع، أي صفوفاً، وفي الحديث الصحيح يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفاً يسمعهم الداعي وينفدهم البصر، الحديث بطوله، وفي حديث آخر «أهل الجنة يوم القيامة مائة وعشرون صفاً، أنتم منها ثمانون صفاً»، وقوله تعالى: {لقد جئتمونا} إلى آخر الآية مقاولة للكفار المنكرين للبعث، ومضمنها التقريع والتوبيخ، والمؤمنون المعتقدون في الدنيا أنهم يبعثون يوم القيامة، لا تكون لهم هذه المخاطبة بوجه وفي الكلام حذف ويقتضيه القول ويحسنه الإيجاز تقديره: يقال للكفرة منهم، {كما خلقناكم أول مرة} يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً {كما بدأنا أول خلق نعيده} [الأنبياء: 104].
وهذا جائز أن يكلفه قوم، فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم «قوموا إلى سيدكم»، ومنه تقبيل أبي عبيدة بن الجراح يد عمر بن الخطاب حين تلقاه في سفرته إلى الشام ذكره سعيد بن منصور في مصنفه، وقوله: {إلا إبليس} قالت فرقة هو استثناء منقطع، لأن {إبليس} ليس من الملائكة، بل هو من الجن، وهم الشياطين المخلوقين من مارج من نار، وجميع الملائكة إنما خلقوا من نور، واختلفت هذه الفرقة فقال بعضها إبليس من الجن، وهو أولهم، وبدءتهم، كآدم من الإنس، وقالت فرقة بل كان إبليس وقبيله جناً، لكن جميع الشياطين اليوم من ذريته، فهو كنوح في الإنس، احتجوا بهذه الآية، وتعنيف {إبليس} على عصيانه يقتضي أنه أمر مع الملائكة، وقالت فرقة إن الاستثناء متصل، وإبليس من قبيل الملائكة خلقوا من نار، فإبليس من الملائكة وعبر عن الملائكة بالجن من حيث هم مستترون، فهي صفة تعم الملائكة والشياطين، وقال بعض هذه الفرقة كان في الملائكة صنف يسمى الجن وكانوا في السماء الدنيا وفي الأرض، وكان إبليس مدبر أمرهم ولا خلاف أن إبليس كان من الملائكة في المعنى، إذ كان متصرفاً بالأمر والنهي، مرسلاً، والملك مشتق من المالكة، وهي الرسالة، فهو في عداد الملائكة يتناوله قول {اسجدوا} وفي سورة البقرة وسورة الأعراف استيعاب هذه الأمور، وقوله: {ففسق} معناه فخرج وانتزح، وقال رؤبة: [الرجز] ومنه قال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وفسقت النواة إذا خرجت عن الثمرة، وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها، وجميع هذا الخروج المستعمل في هذه الأمثلة، إنما هو في فساد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم «خمس فواسق يقتلن في الحرم إنما هن مفسدات» وقوله: {عن أمر ربه} يحتمل أن يريد خرج عن أمر ربه إياه، أي فارقه كما فعل الخارج عن طريق واحد، أي منه، ويحتمل أن يريد فخرج عن الطاعة بعد أمر ربه بها، و{عن} قد تجيء بمعنى بعد في مواضع كثيرة، كقولك أطعمتني عن جوع، ونحوه، فكأن المعنى: فسق بعد أمر ربه بأن يطيع ويحتمل أن يريد فخرج بأمر ربه أي بمشيئته ذلك له ويعبر عن المشيئة ب الأمر، إذ هي أحد الأمور، وهذا كما تقول فعلت ذلك عن أمرك أي بجدك وبحسب مرادك، وقال ابن عباس في قصص هذه الآية: كان إبليس من أشرف صنف، وكان له سلطان السماء وسلطان الأرض، فلما عصى صارت حاله إلى ما تسمعون، وقال بعض العلماء إذا كانت خطيئة المرء من الخطأ فلترجه، كآدم، وإذا كانت من الكبر، فلا ترجه، كإبليس، ثم وقف عز وجل الكفرة على جهة التوبيخ بقوله: {أفتتخذونه} يريد أفتتخذون إبليس، وقوله: {وذريته} ظاهر اللفظ يقتضي الموسوسين من الشياطين الذين يأمرون بالمنكر ويحملون على الأباطيل، وذكر الطبري أن مجاهداً قال: ذرية إبليس الشيطان، وكان يعدهم: زلنبور صاحب الأسواق، يضع رايته في كل سوق، وتبن صاحب المصائب، والأعور صاحب الربا، ومسوط صاحب الأخبار، يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس، ولا يجدون لها أصلاً، وداسم الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم الله بصره من المتاع ما لم يرفع.قال القاضي أبو محمد: وهذا وما جانسه مما لم يأت به سند صحيح فلذلك اختصرته، وقد طول النقاش في هذا المعنى، وجلب حكايات تبعد من الصحة، فتركتها إيجازاً، ولم يمر بي في هذا صحيح إلا ما في كتاب مسلم من أن للوضوء والوسوسة شيطاناً يسمى خنزت، وذكر الترمذي أن للوضوء شيطاناً يسمى الولهان والله العليم بتفاصيل هذه الأمور لا رب غيره، وقوله: {وهم لكم عدو} أي أعداء، فهو اسم جنس، وقوله: {بئس للظالمين بدلاً} أي بدل ولاية لله عز وجل بولاية إبليس وذريته، وذلك هو التعوض من الجن بالباطل، وهذا هو نفس الظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه.
|